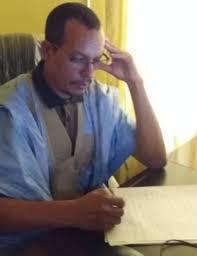عالي ولد أعليوت
تُعتبر المهرجانات الثقافية إحدى أبرز التظاهرات التي شهدتها موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، حيث أُقيمت في مختلف أنحاء الوطن تقريبا، بعد أن كانت شبه محصورة في مدن تاريخية كشنقيط وودان وتيشيت وولاتة، تحت شعار إحياء التراث الوطني وتعزيز الهوية الثقافية، غير أن هذه الفعاليات، التي تكتسي طابعاً احتفائياً، تُثير جدلاً متزايداً حول أهدافها الحقيقية: هل تمثل بالفعل رافعة للتنمية المحلية والمحافظة على التراث، أم أنها أقرب إلى مبادرات سياسية ظرفية تخدم أجندات آنية؟
لا جدال في أهمية البعد الثقافي والتراثي للمهرجانات، خصوصا تلك التي تنظم في المدن التاريخية والتي شكلت مراكز إشعاع علمي وتجاري في العصور الماضية، ما يمنحها بعداً رمزياً مهماً، يجعلها أهلا لأن تخص بمثل هذه المهرجانات من أجل تسليط الضوء على ما تكتنزه من مخزون تقافي وتثمين وتعزيز دورها المحوري في التنمية عبر المحاور التالية:
إحياء التراث المادي واللامادي: من خلال العروض الفنية، المعارض التقليدية، وإبراز المخطوطات النادرة.
التعريف بالهوية الوطنية عبر الاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي يشكل ثراءً لموريتانيا.
تعزيز الروابط الاجتماعية: إذ توفر المهرجانات فضاءً يلتقي فيه المواطنون من مختلف المناطق، مما يعزز التماسك الاجتماعي.
لكن ظاهرة المهرجانات لم تعد تتقيد بزمان ولا مكان وانتشرت عدواها حتى عمت ربوع الوطن، دون الخضوع لمعايير ضابطة، ولا الاستجابة لبرامج تنموية واضحة، ولا حتى أهداف محددة قابلة للقياس. أما ما يخص الغايات التنموية المعلنة، فإن هذه التظاهرات تُسوّق عادةً باعتبارها آلية لدفع عجلة التنمية المحلية، خصوصاً في المدن الداخلية المهمشة. ومن أبرز الأهداف التنموية التي يُفترض أن تحققها:
إنعاش السياحة الداخلية والخارجية عبر استقطاب الزوار لاكتشاف المنطقة المضيفة للمهرجان.
تنشيط الاقتصاد المحلي: حيث تستفيد الفنادق، الحرفيون، والباعة الصغار من الحركة التجارية المؤقتة.
خلق فرص عمل موسمية: من خلال تشغيل الشباب في التنظيم والخدمات المرتبطة بالمهرجانات.
غير أن هذه الآثار، في الغالب، تكون محدودة زمنياً إن لم نقل معدومة ولا تترك أثراً دائماً في تحسين البنية التحتية أو الرفع من المستوى المعيشي للسكان.
لم تترك هذه المهرجات ـ حيث مرت ـ أثرا إيجابيا يناسب حجم ما ينفق عليها من أموال، فضلا عنما تخلفه وتسببه أحيانا من إحياء للصراعات المحلية، حيث يرى كثير من المراقبين أن للمهرجانات الثقافية أبعاداً سياسية لا تقل أهمية عن جوانبها التراثية. فهي غالباً:
منصات لإبراز حضور الدولة: إذ تحرص السلطات العليا على رعاية هذه التظاهرات وإلقاء خطابات سياسية ضمنها.
وسيلة لتعزيز الشرعية: حيث تُستثمر المهرجانات لتقوية الصلة بين النظام الحاكم والمواطنين، خصوصاً في المناطق النائية، حتى ولو كان الأمر مطلوبا فإن ذلك لا ينفي عنه صبغة السياسة، خصوصا أن الوسائل البديلة متاحة.
مناسبات انتخابية غير مباشرة: إذ غالباً ما تشكل هذه المهرجانات ساحة صراع بين الفاعلين السياسيين، الذين يحولون دائما الالتفاف على كل نشاط ليظهروه على أنه من إنجازهم ما يجعلها أقرب إلى أدوات تعبئة جماهيرية.
ستبقى إشكالية الاستدامة وضعف الأثر التنموي لهذه المهرجانات مطروحة ما لم تكن هناك رؤية وطنية تؤطرها وترسم الأهداف التنموية العامة التي من المفترض أن تشكل نبراسا يستضيئ به منظموها. ما لم يتحقق ذلك، يظل السؤال مطروحاً: ما الذي حققته هذه المهرجانات عملياً على مستوى التنمية المحلية؟
البنية التحتية في أماكن تنظيم هذه المهرجانات ما تزال محدودة أو معدومة في الغالب الأعم.
الهجرة نحو العاصمة مستمرة بسبب ضعف الخدمات.
المشاريع الاقتصادية المستدامة غائبة تقريباً.
هذا الواقع يعزز الانطباع بأن المهرجانات لا تتجاوز كونها أحداثاً موسمية تنتهي بانتهاء أيامها، من دون خطط متابعة أو رؤية إستراتيجية واضحة.
لجعل المهرجانات الثقافية أكثر فاعلية وارتباطاً بالتنمية الحقيقية، ينبغي:
ربطها بمشاريع دائمة، حسب خصوصيات وأولويات كل منطقة، كإنشاء متاحف، مراكز بحثية، وبنى تحتية سياحية.
إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ لضمان استفادتها المباشرة.
تسويق الموروث الثقافي والمنتج المحلي وطنيا ودولياً ضمن شبكات السياحة الثقافية الوطنية والعالمية.
فصل الطابع السياسي عن الثقافي عبر استقلالية اللجان التنظيمية وشفافية التمويل.
يمكن القول إن المهرجانات الثقافية في موريتانيا تحمل في طياتها مزيجاً من الغايات؛ فهي من جهة تجسد احتفاءً بالتراث والهوية الوطنية ولو بشكل لا يرقى للمستوى المطلوب، ومن جهة أخرى فإنها تُوظف سياسياً في سياقات مختلفة. لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويلها من مجرد مناسبات موسمية إلى رافعة تنموية حقيقية، تحقق استدامة اقتصادية واجتماعية للمناطق التي تحتضنها، بعيداً عن الحسابات السياسية الظرفية، والمآرب الشخصية الضيقة.